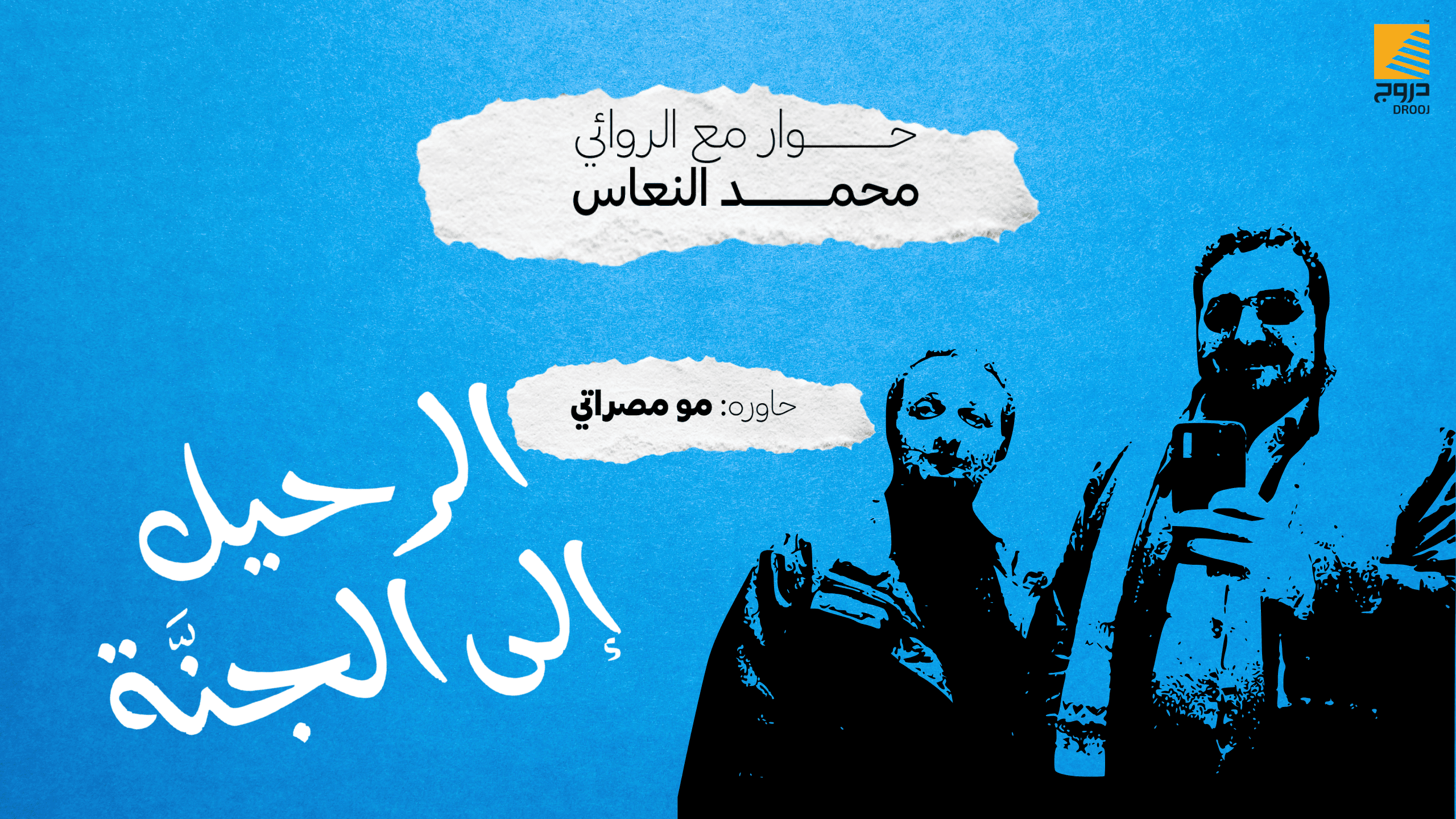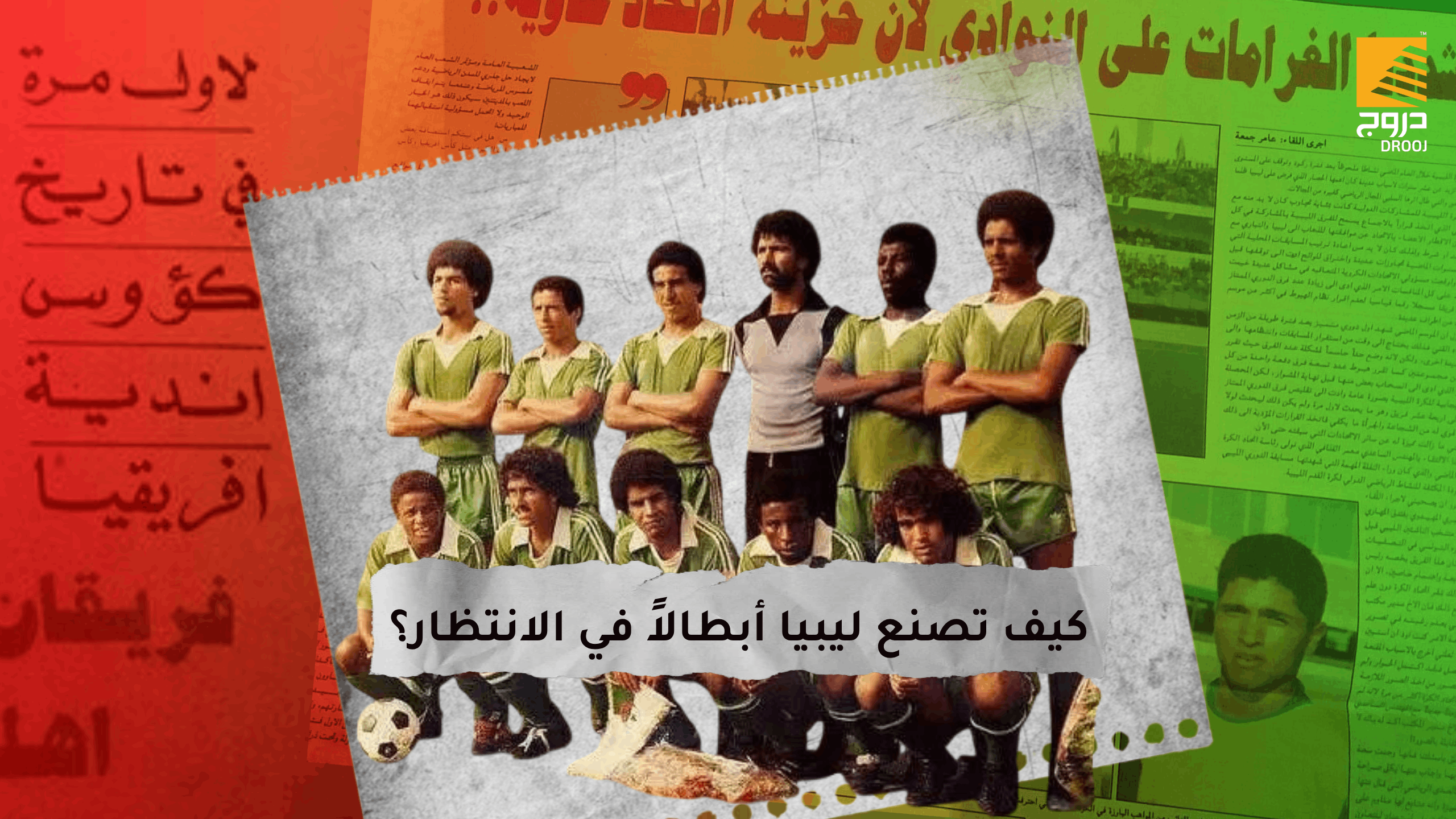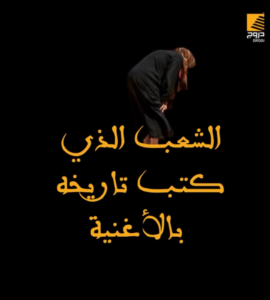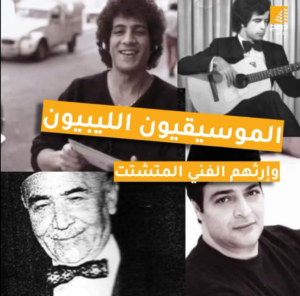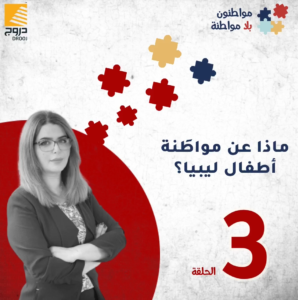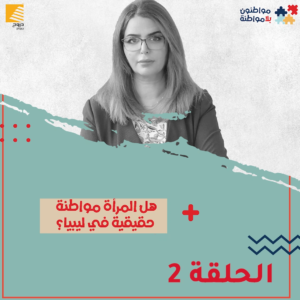من الطْبُرْنة إلى الميثانول: سيرة الكأس في ليبيا
الخمر في ليبيا واقع مستمر منذ الأزل، يتغيّر موقعه مع تغيّر السلطة والقانون، ويتنقل بين العلن والسرّ. زجاجة تُخبّأ تحت كرسي سيارة، أو قنينة بلاستيكية تُرفع خلسة على شاطئ، أو كأسًا وضعت ذات يوم على طاولة طبرنة في طرابلس أو بنغازي. وبين اللاقمي المُستخرج من قلب نخلة، ونبيذ جلبه الإيطاليون، وبوخة أو قرابّا مصنوعتان في البيوت، ظلّ الخمر حاضرًا، يتحوّل ولا يزول. مساحة صامتة يتفاوض فيها الليبي مع القانون، ومع الدين، ومع نظرته لنفسه وللآخرين.
هكذا، فإن تاريخ الكحول هنا هو أيضًا تاريخ ما يُقال وما يُخفى، وما يُمنع في النص ويُمارس في الواقع.
كانت الحانات أو ما كان يُعرف بـ الطبرنات جزءًا من المشهد الاجتماعي في المدن الكبرى مثل طرابلس وبنغازي. هذه الأماكن كانت صغيرة وبسيطة، يديرها مالطيون ويهود ليبيون وإيطاليون، وأحيانًا عائلات ليبية ذات طابع مديني. زبائنها كانوا مزيجًا من بحّارة وموظفين حكوميين وجنود وعمّال موانئ، وبعض الوجهاء أو المتعلمين.
انتشرت هذه الطبرنات في الأحياء التي بناها الإيطاليون أو قرب الميناء، وقُدّمت فيها الخمور المستوردة والنبيذ المحلي والمقبلات البسيطة مثل الزيتون والخيار المخلل. في القرى والريف كان الشرب يعتمد على ما يُصنع محليًا في البيوت أو المزارع، وكان الأمر يتم في نطاق ضيق، مرتبط بالضيافة أو المناسبات الخاصة، وليس جزءًا من حياة “سهر علني” كما كان الحال في المدن.
بعد الفاتح 1969، تغيّر موقف الدولة جذريًا. تحوّل الكحول إلى “رمز للانحطاط الملكي”، وصدر قانون 89 لسنة 1974 بتحريمه وإقامة حدّ الجلد للمسلم الشارب مع السجن. وفي التسعينيات اشتدت العقوبات وتحولت بعض قضايا الخمر إلى جنايات.
انتقل استهلاك الخمر في تلك السنوات إلى الخفاء وتبدّلت أشكاله.
في الثمانينيات، صار الشرب يتم سرًّا في الأعراس، داخل غرف جانبية، أو خلف الخيام بعيدًا عن الأنظار.
ومع التسعينيات، تقلّصت المساحات الآمنة أكثر، فاتخذت السيارة مكانها كـ “غرفة شرب متنقّلة” تُركن في شارع جانبي أو قرب البحر.
في الوقت نفسه انتشرت الصناعة المنزلية للبوخة والقرابّا ونبيذ العنب، وازدهر تهريب الخمور من تونس ومالطا ومصر.
في 2010 لمّح سيف الإسلام القذافي إلى إمكانية السماح المنظّم ببيع الخمور لدعم السياحة، كما تفعل دول إسلامية أخرى. كان التصريح أشبه بمحاولة لإعادة التفكير اقتصاديًا، ودون المساس بجوهر النظام. لكن الردّ كان سريعًا وحادًّا. خرجت أصوات من شيوخ ودعاة وفقهاء وأساتذة شريعة تهاجم الفكرة بشدّة، معتبرة أنها “اعتداء على هوية المجتمع” و”تمهيد لفتح باب الفساد”. كتّاب وصحفيون محافظون دخلوا على الخطّ أيضًا، ووجّهوا انتقادات لسيف الإسلام واتهموه بمحاولة “استيراد سياحة على حساب الدين”.
أما هيئة الأوقاف فكان موقفها حاسمًا؛ أصدرت بيانات تذكّر بأن قانون تحريم الخمر لا يزال ساريًا، وأنه يُطبّق حتى على الرحلات الجوية الأجنبية عندما تدخل الأجواء الليبية، حيث تُمنع من تقديم أي مشروب كحولي. وُئدت الفكرة مبكرًا قبل أن تتحول إلى مشروع أو حتى إلى نقاش مؤسسي، لكنها كشفت التوتر العميق بين من يرى الهوية مجالًا اقتصاديًا قابلًا للتعديل، ومن يراها خطًا دينيًا لا يُمَس.
بعد 2011، ومع سقوط مؤسسات الأمن والقضاء، تحولت طُرق استهلاك الكحول، وإنما هذه المرة بلا دولة تنظّم ولا شرطة تضبط، بل سلاح وميليشيات وسوق سوداء مفتوحة.
في طرابلس، خصوصًا في منطقة قرقارش، أصبحت تجارة الخمر واحدة من مصادر الدخل لعدد من الشبكات المحلية بعد أن كانت محتكرة من قبل عصابات محدودة ومعروفة.
بدأت مجموعات دينية مسلّحة على رأسها ما عُرف وقتها باسم “هيئة الأمر بالمعروف”، بمداهمة البيوت والمخازن التي تُخفَى فيها الخمور، وتدمير الزجاجات علنًا. لكن في كثير من الحالات، اصطدمت هذه المجموعات بمهربين مسلّحين أيضًا، يعتبرون بيع الخمر “رزقًا” لا يمكن تركه، لينتهي الأمر باشتباكات مسلّحة في الشوارع أو على أطراف الأحياء الساحلية.
ومع غياب الحانات انبثقت ظاهرة الاستراحات؛ وهي بيوت في مزارع على أطراف المدن تُستأجر لساعات أو ليلة كاملة، لتصبح فضاءً خاصًا وآمنًا للشرب بعيدًا عن الشارع والعائلة. تُفتح غالبًا بين الأصدقاء أو المعارف الموثوق بهم، خصوصًا في ليالي الويكند أو للمناسبات.
في الاستراحات تُغلق الأبواب، تُطفأ الهواتف، وتبدأ السهرة: إضاءة خافتة، دي جيه ومنظومة موسيقى، وأحيانًا آلات بسيطة، وخمر يُقدَّم إلى جانب الأرجيلة وربما مخدرات خفيفة. ومع انتشارها، تحولت هذه الاستراحات إلى البديل العصري للحانة القديمة، وإلى جزء من اقتصاد غير رسمي يوفّر الخصوصية وحق السهر، وهدنة مؤقتة من أعين المجتمع والقانون.
ثم جاءت اللحظة التي تحوّل فيها الخمر من فعل سرّي إلى مأساة جماعية.
في مارس 2013، شهدت طرابلس موجة تسمّم جماعي غير مسبوقة: أكثر من ستين وفاة، وما يزيد عن سبعمئة إصابة، بعد تناول خمور مغشوشة بمادة الميثانول. امتلأت المستشفيات بحالات فقدان بصر وفشل كلوي وغيبوبة، فيما وقف الأطباء أمام كارثة بلا تجهيزات كافية ولا دواء مضاد، ولا بروتوكول صحي واضح.
بعد أحد عشر عامًا، تكرّر المشهد في بنغازي أواخر 2024، بنفس التفاصيل تقريبًا: خمر مغشوش، موت مفاجئ، شباب أصيب بعضهم بالعمى وآخرون فقدوا الكلى، وأسر تنتظر بين العناية المركزة والمشرحة. في تلك اللحظات، لم يعد الموضوع مجرّد “سكر محرّم”، بل تحوّل إلى جريمة تسميم وغياب كامل لدور الدولة في الرقابة والحماية.
غابت الخمرة المراقَبة والمنظمة، فحضر السم.
وهكذا، ظلت الزجاجة موجودة كإنها تعكس تحولات ليبيا في السبعين سنة الماضية، تنتقل صناعتها من المصنع الرسمي إلى المطبخ، واستهلاكها من الحانة إلى الاستراحة. تقول التجربة إن التحريم لا يُبطل الواقع، بل يبدّل أماكن التعاطي ويضاعف الخطر. وما حدث في طرابلس سنة 2013، ثم في بنغازي أواخر 2024، يشير إلى أن المأزق الأكبر ليس في مجرد وجود الخمر بقدر ما هو في غيابه عن أي رقابة، حين تتحول الزجاجة من مشروب إلى سمّ ممزوج بالميثانول. هذه الحوادث تذكير بأن تجاهل ما يحدث لا يمنعه من التكرار. فقد يختلف الليبيون حول الحلال والحرام، لكنّهم، ربما، يتفقون على أن حياة البشر لا ينبغي أن تُترك فريسة للغش والخوف والقتل العبثي.