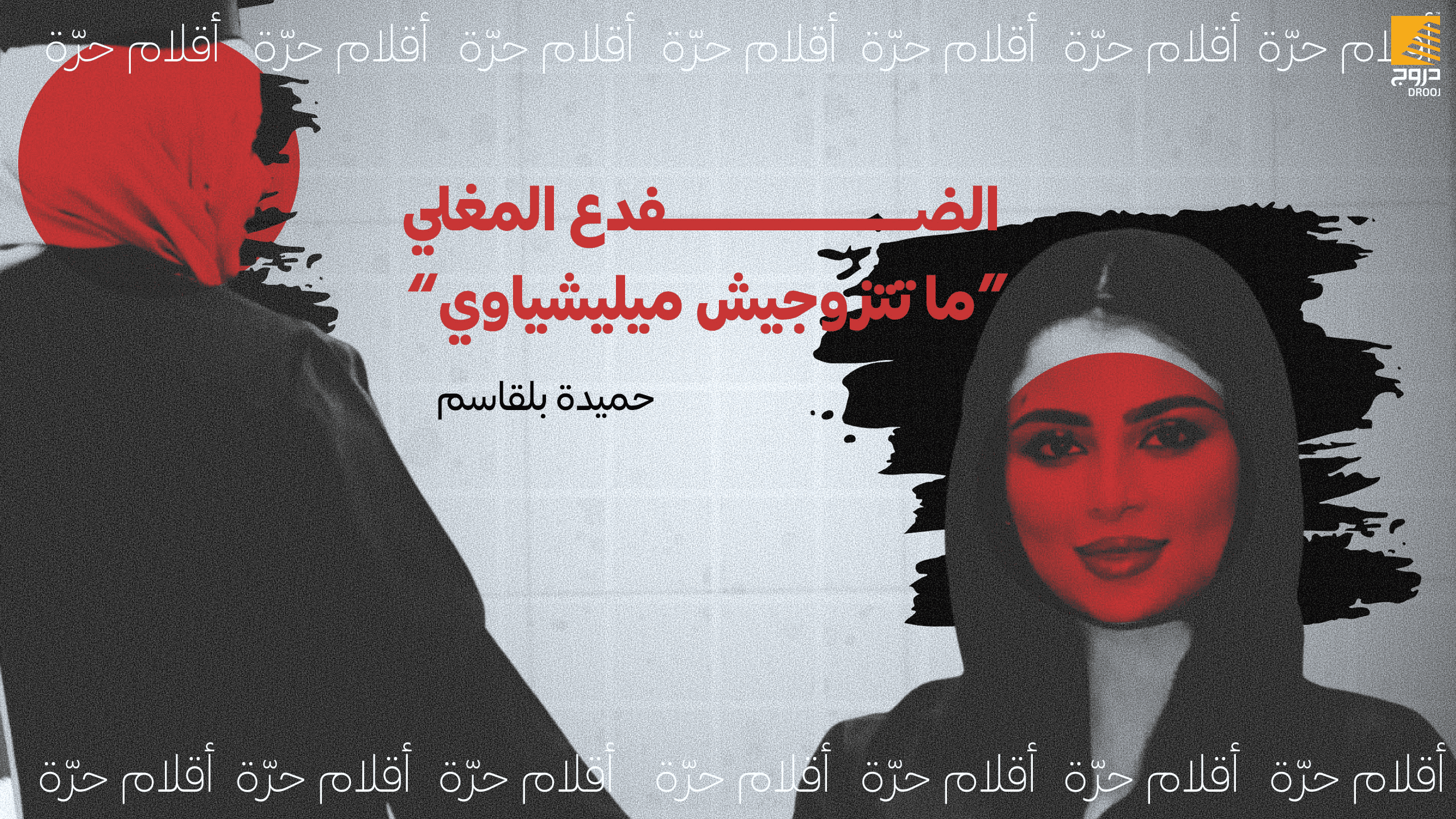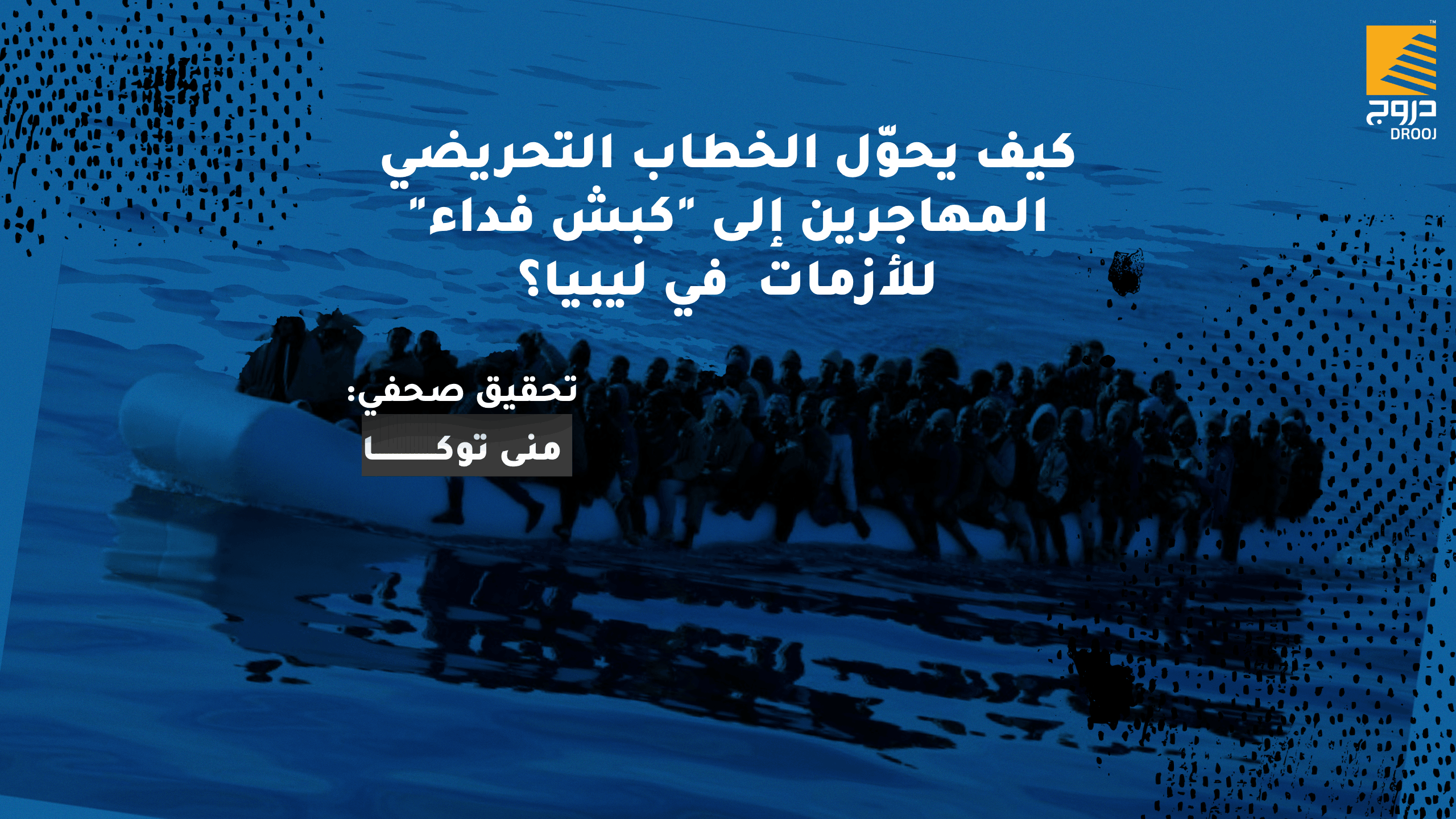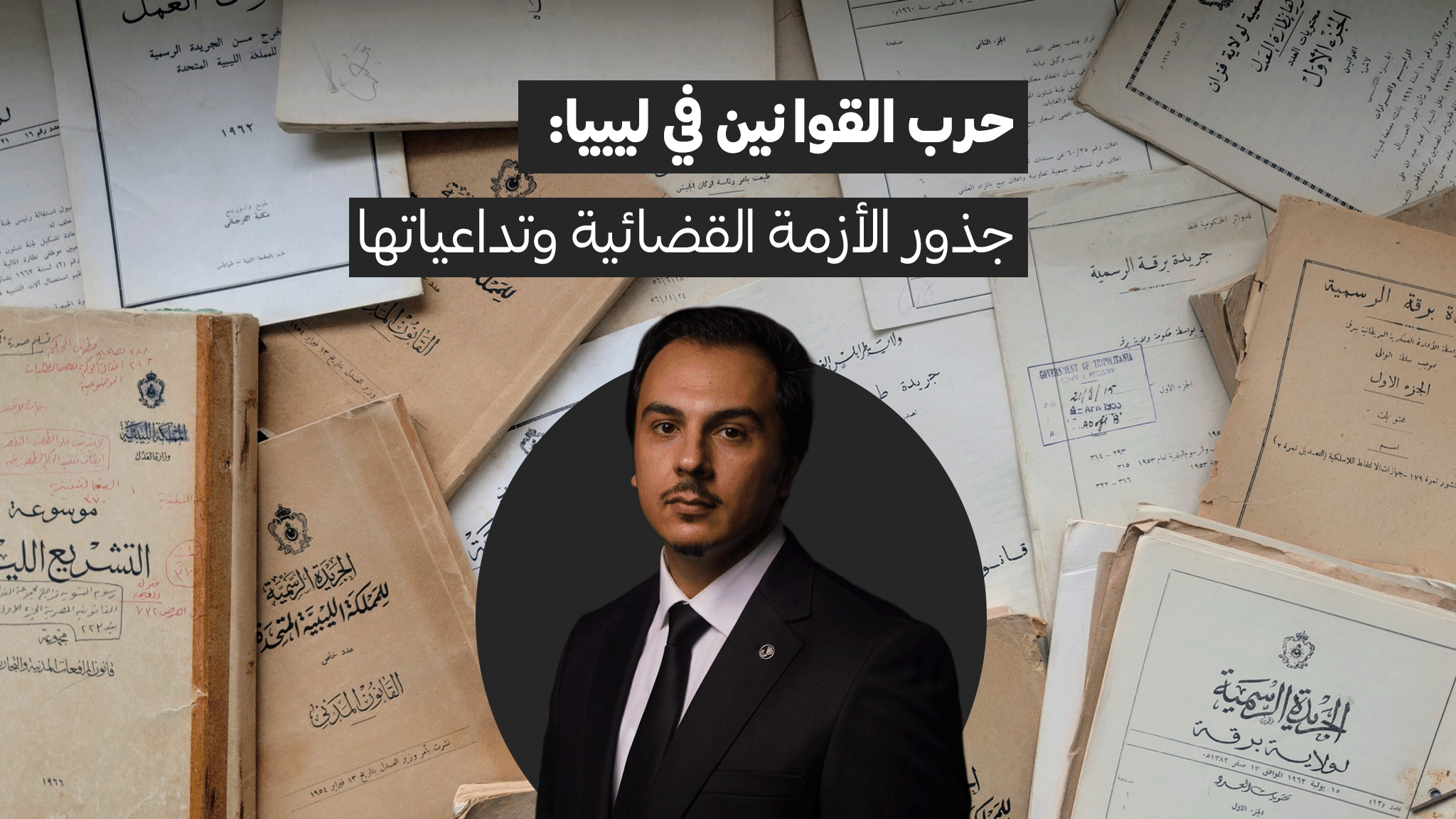حميدة بلقاسم: الضفدع المغلي.. “ما تتزوجيش ميليشياوي”
مُمدّدة على الأرض في محاولتها الأخيرة للنجاة، هزّت جريمة اغتيال سيدة الأعمال الخنساء مجاهد المجتمع الليبي، وطفَت كلّ ذكريات الخوف على السطح من جديد. توارى جسدها تحت غطاء باهت، أخفى رصاصة اخترقت رأسها لتنهي حيوات، لا حياة واحدة.
قتامة صورة موت الخنساء وبلاغتها مروّعة، وكأن القاتل أراد بثّ سردية خوف أبدي عبر صناعة مشهدية تسيطر عليها عقلية تبرّر الموت كنتيجة محتومة للأفعال. يستخدم بعض الليبيين جملة تجنّبية من قبيل سدّ ذرائع الشر: “اللي ما يدير شي ما يجيه شي”.
بعد كل ضحية نلجأ إلى هذه المقولة، تسعفنا غالباً وتنجح في تخفيف عبء نصرة الضحايا دائماً.
أين اختفت أحلام أماني والخنساء؟
أماني جحا، فتاة ليبية، أم وطبيبة. قصة رحيل صادمة وُلدت في العتمة عندما غدر بها أحد أفراد عائلتها وألقى جثمانها في خزان صغير للصرف الصحي في منزل العائلة. ملابسات مرعبة، إذ تشير الاستدلالات الأولية إلى أن الأسرة استطاعت تضليل العدالة لأيام من خلال تلفيق رواية انتحار مزعومة في البحر، حيث زعم شقيقها بأن الشابة “مسحورة”، لذلك أقدمت على إنهاء حياتها غرقًا.
انطلقت بعد ذلك جهود إنقاذ في محاولة للعثور على جثة الطبيبة وتكريمها بقبر على أقل تقدير، لتكشف خيوط الحقيقة عن مستوى غير مسبوق من مقتلة غير معلنة تستهدف الفتيات بقائمة ضحايا مفتوحة.
عنف اجتماعي
تعيش النساء في ليبيا واقعًا معقدًا يصطدم بالتشتت الأمني والتنافس بين الميليشيات وحملات التحريض الاجتماعي. يتلاشى كل شيء في الخلفية، إذ يصعب الإمساك بجذور الموت أو الاضطهاد المعنوي الذي يتلقّف كل ما هو أنثوي منذ الطفولة، بدءًا من منظومة التكوين الأولي التي ترسّخ دونية شمولية، وصولًا إلى إجماع مجتمعي يجبر المرأة على الانفصال عن ذاتها وتزييف أفكارها للحصول على القبول ومواصلة العيش في أمان نسبي.
متلازمة الضفدع المغلي
مع أول جريمة قتل طالت فتاة (وهي الضحية “س” المفترضة)، ومنذ اندثار أبسط مظاهر الدولة وتسلّح الجميع، تظاهرنا بالهدوء وبحثنا عن الأسباب. تلك الواقعة كانت بعيدة ومعزولة، ولم تنجح بدايةً في ترويض الأخريات. اعتبرنا وقاحة المشهدية شأنًا شخصيًا للغاية ولن تشتبك مع واقعنا—ربما أقدم قاتلها على فعل ذلك بدافع “الشرف”، أو درءًا لشبهة وإنهاء كل ما يفعّل امتدادها بوجود الضحية تتنفس وترصدها الأعين.
توالت القصص، فرّقت الأبجدية بين الوجوه المغدورة وجمعت النتيجة وقسوة المصير شتاتهنّ، وتحولت أحلامهنّ إلى خبر عابر. هل الخنساء هي البداية؟ مكمن السؤال يسوق مجموعة من التفاصيل تُطلق يد الجلاد وتُوقع الضحية في مستنقع التأكيدات التي ترسم النهايات.
هل اعتدنا قتل النساء؟ بعد سنوات من تراكم مشاهد سوداء تعمّد الجناة نشرها بالعرض البطيء إمعاناً في الترهيب، حوصرت الأماني وحُطّمت شرفة الغد، وباتت فظاعة الجرائم وتقارب توقيتاتها العامل الأهم في فصول النسيان والتعوّد وربما السخرية.
لن يكون ذلك حدثًا جللًا أو شاذًا، فالعقل يحمينا من هول الواقع بحيلة دماغ الضفدع، إلى أن نكون الضحية التالية.
تواطؤ تشريعي
في بلد لم يسنّ يومًا أي قوانين صارمة تحمي النساء بشكل قطعي، ولم يُحارب العنف كظاهرة تهدد الحياة أو تحطم قيم المجتمع، سيكون من المنطقي جدًا أن يتعثّر أي مشروع جاد يوقف هذا النزف. ففي عام 2017 أُعدّت مسودة قانون مكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا، ولم يتم اعتمادها من قبل البرلمان الليبي في طبرق حتى الآن لأسباب واهية، حتى بعد تقديم النسخة المنقّحة منها في العام 2021.
كما يمنح القانون الليبي المغتصب فرصة لتفادي السجن عبر عقد قرانه على الضحية، ومن باب الستر وحماية الفتاة من شبح الوصمة يتم تزويجها لتتوارى عن الأنظار وتسترجع عفتها المفقودة عنوة، “فالعار أطول من العمر”.
بعد كل جريمة، غالبًا ما ينجلي غبار المعركة دون أي جدوى، حتى وإن تمت معاقبة الجاني، فالمجتمع لا يعترف بأبعاد الظاهرة. في ليبيا لا يمكن إنكار الفروق الجندرية بين الذكور والإناث؛ إذ ينشأ الذكر بمواصفات كاملة تمنحه صلاحيات حصرية، فيما تتلقى الإناث تربية بأسس مجتمعية مشككة في كمال خلقتها، ما يجعلها تخرج إلى المجتمع بروح متناقضة قد تدفعها لممارسة النفاق كي تحظى بالقبول الاجتماعي.
بعضهنّ لا بواكي لهنّ
قُتلت عندما كان والدها أو أحد أفراد عائلتها ينظف السلاح “الكلاشنكوف”. هكذا يتم التستر على بعض الجرائم المقترفة بحيل مكشوفة لكنها ناجعة. قبليًا، وفي بعض مناطق البلاد، يمكن محو آثار الواقعة برواية عائلية على النحو التالي: “ماتت بالغلط”. يُقفل على إثرها الملف بأخف الأضرار، ولا ترى قصة الضحية النور أو تتحقق لها العدالة.
جلسات نسائية
عمليًا، تقضي معظم الفتيات والنساء في ليبيا سنوات طويلة من حياتهنّ تحت الوصاية. في هذه الحالة تتأرجح أمامهنّ خيارات محدودة، تتراوح بين التعايش أو المزيد من التعايش الممزوج بالصمت؛ فالبيوت أسرار، حتى وإن أفضت إلى الموت.
تقبلت النساء هذا السيناريو بثقة تجعلهنّ يقاومن أي مبادرة للتغيير أو الحماية، بل وتفتخر بعضهنّ في الجلسات النسائية المغلقة بمستوى ما يتعرضنّ له من قمع، تارةً بروحانية دينية وتارةً أخرى بمزايدات ما أنزل الله بها من سلطان.
في مثل هذه الجلسات، قد تعرّض المطالبة بالحق في الحياة وتقرير المصير صاحبتها إلى الطرد من رحمة الله.
“ما تتزوجيش ميليشياوي”
كي يتنصّل المجتمع، ومعه الدولة، من واجب تأمين حياة الفتيات، لجأ البعض إلى إجراء تعسفي بإطلاق حملة “ما تتزوجيش مليشياوي”. هنا يبرز الحد الفاصل بين المنطق والشروع في القتل عبر تسطيح المشكلة والترويج لفكرة الاختيار الخاطئ من البداية، ما يحمّل الضحية المسؤولية التامة عن قسوة مصيرها.
“تحديد الكل” جملة تروق لمعظم الليبيين، إذ لا يتم التعامل مع ظاهرة العنف كنتيجة لغياب الدولة أو كونها جزءًا من الموروث الاجتماعي في التعاطي مع الفتيات، بل تُتّهم كل الضحايا بسوء الاختيار أو ارتكاب أفعال تخالف معايير المجتمع، ما يؤهلنا بالفعل لأن نكون شهود زور وشياطين خرساء.
ببساطة، يمكن رصد مظاهر عنف خفي ومعنوي ضد الفتيات والنساء في كل مكان: في الشوارع، عند قيادة السيارة، أو على منصات التواصل، وكلها بغطاء ديني أو عرفي. ما لم يُفتح نقاش مجتمعي شامل يحدّد جذور المشكلة ويجتثّ كل ما يغذّيها، لن تكون أماني أو الخنساء آخر الضحايا.