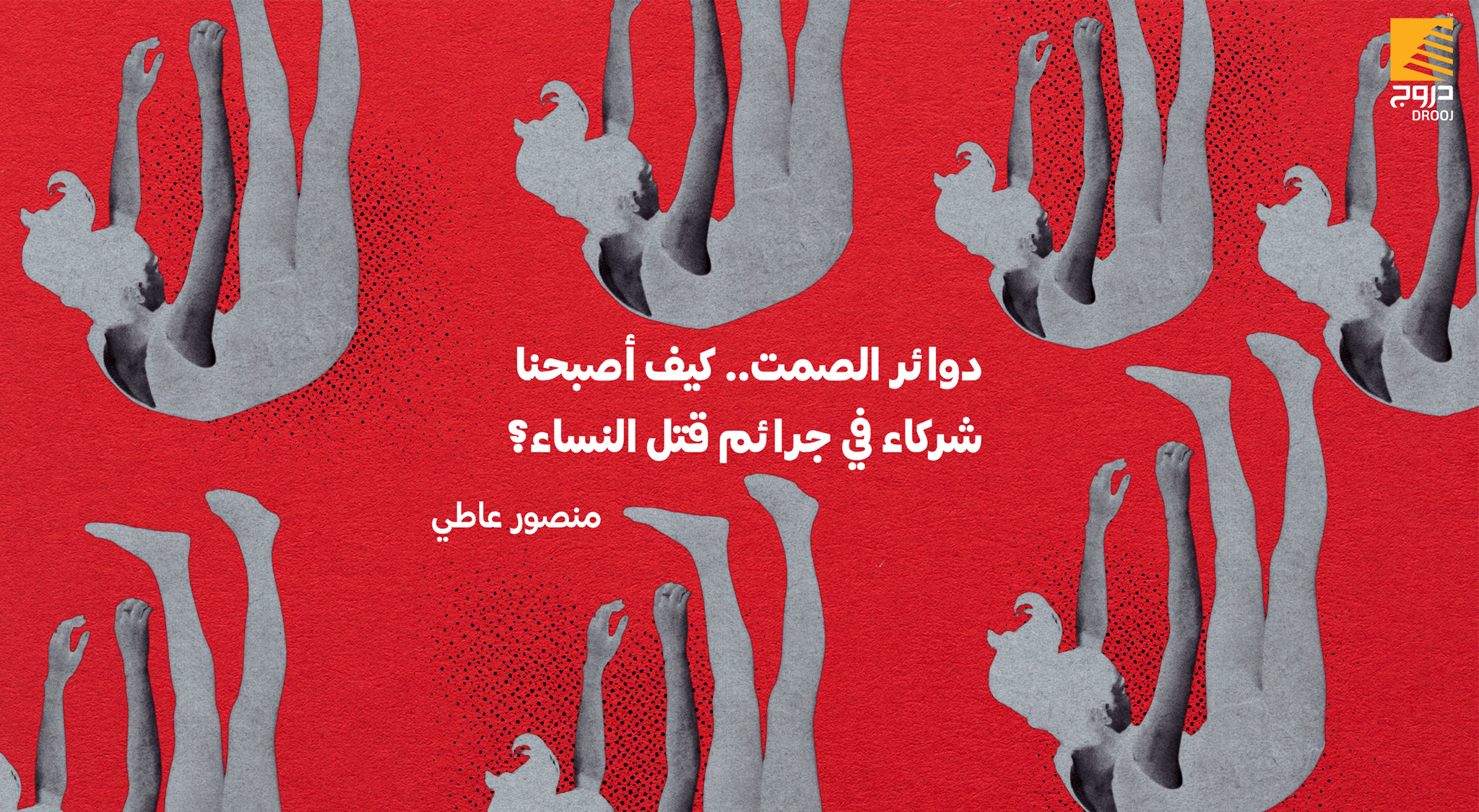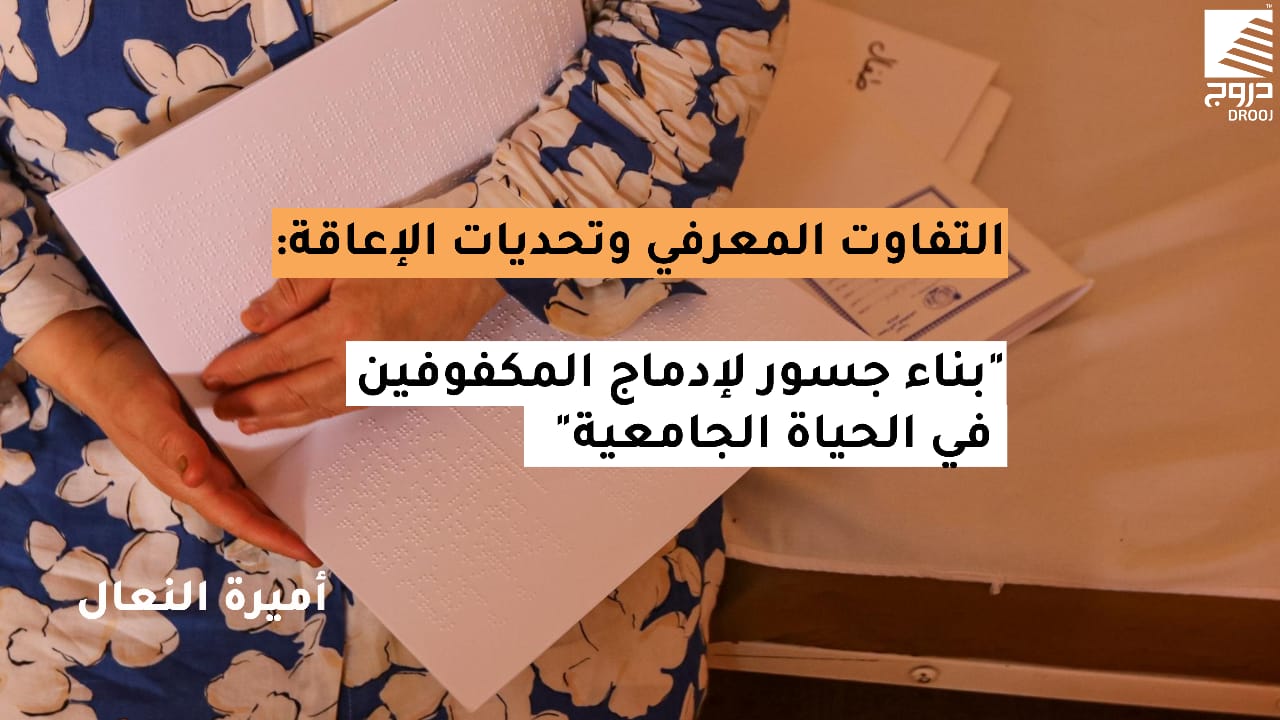منصور عاطي: دوائر الصمت.. كيف أصبحنا شركاء في جرائم قتل النساء؟
ظاهرة العنف ضد النساء في ليبيا، لم تعد ظرفًا عابرًا كبقية ما نعيشه، بل أصبحت كارثة صامتة، تتجاهلها الأخبار، وتقفل على محاضرها المراكز والأقسام، بعد أن تصاعدت إلى حوادث متكررة لقتل النساء. وبالحديث عن قتل النساء كجريمة مجتمعية، تموت النساء بيننا أكثر من ميتة، حيث الموتة الأولى في الفعل في ذاته (القتل)، وهو ما يتم تبريره –على الدوام- بإحصائيات متناثرة من العالم أجمع في محاولة بائسة لتسويغ زهق الأرواح، ولكن ما يتعقد تبريره هو عملية (إجهاض القضايا)، من خلال عدم نشر أي معلومات عنها ووأدها في مقابر العرف وأسرار البيوت، وهي الرصاصة الثانية التي تصيب الضحايا في مقتل أبدي.
الصمت السلبي والمتعمد
الصمت العائلي، والذي غالبًا ما يأتي لأجل محاولة إخفاء الأدلة والتستر على الجاني، خاصة أن هذا الجاني عادة ما يكون من العائلة نفسها. بالإضافة إلى الخوف من وصم المجتمع أو نبذه، حيث يهتم المجتمع –بشكل هوسي- بالغوص في سيرة الضحية والتشكيك بشرفها، بينما يمنح الجاني نيشان الفروسية، وهو ما يخلق آلية دفاعية داخل الأسرة بحماية الجاني، وإنهاء سيرة الضحية بجملة واحدة (خلاف عائلي). وهذا الخلاف بطبيعته، يقود العقل الجمعي إلى قناعة مفادها أن الضحية “تستاهل ما جاها” وأن أهلها أدرى بمصلحتها، بما في ذلك القتل، الذي تم التطبيع معه مجتمعيًا حتى أصبح “شأنًا خاصا” ولم يعد مقتل إنسان قضية رأي عام.
الصمت المؤسسي والأمني، والذي يتمثل في عدم فتح ملف القضية بشكله القانوني، بل تعمد الأجهزة الأمنية وكذلك القضائية –للأسف- إلى تمكين وتغليب العرف والحلول الاجتماعية على القانون ومحاسبة الجناة، وكما نعلم، فالأعراف هي ذريعة القبائل والمجتمع للإفلات من قبضة القانون وحماية الجُناة تحت غطاء “أعراض ناس”.
الصمت الحقوقي والوقوع في فخ “اللاجدوى”، إذ يُفضّل الناشطون الانسحاب والابتعاد عن الموضوع برمته، بين لا مبالٍ ومن أصيب باليأس من إحداث تغيير، بسبب صمت الأجهزة الأمنية وعائلات الضحايا، وهو عادة ما يؤثر في عمل الصحفيين/ات والمدافعين/ات والمجتمع المدني بشكله الأوسع.
غياب الأرقام من غياب الحقيقة
رغم صعوبة التوثيق والوصول، إلا أن المدافعات عن حقوق المرأة والمنظمات الحقوقية، رصدت خلال عام 2025 -فقط- مقتل 30 امرأة جراء عنف مباشر سواء (أسري أو عبر مقاتلي الميليشيات)، مما يعكس تحول هذه الانتهاكات إلى نمط واقعي، ولم تعد مجرد حوادث عابرة. ويظهر ذلك بوضوح في العنف الإلكتروني الذي يطال الصحفيات والناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة، وهو ما رصدته منظمة (محامون من أجل العدالة) في تقريرها “مقموعون ومهمّشون”، والذي يرصد حملات العنف والقمع الممنهج ضد العاملين والعاملات في المجتمع المدني، حيث أفاد التقرير “أن للعنف الإلكتروني في ليبيا آثارًا كبيرة على إعمال حقوق المرأة ما بعد 2011، وتعتبر آثاره وخيمة وعلى نطاق واسع، وغالبًا ما عانت النساء المنخرطات في النشاط عبر الإنترنت من تعرضهن للاختفاء القسري والاختطاف، والتحرش الإلكتروني”.
وفي بيان لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في شهر مايو 2025 قالت: “أنها تتابع بقلق بالغ ازديات معدلات العنف ضد النساء، كما شددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أن للنساء والفتيات الحق في العيش بأمان وكرامة، بعيدًا عن الخوف والعنف والتهجير”.
ومع كل هذا، تظل الضحية مجرد رقم في السجلات، في المستشفى، ومركز الشرطة، وبيانات المنظمات الحقوقية، أو سجلات السجل المدني كمتوفية. ناهيك عن تقاعس السلطات عن الإيفاء بحقوق النساء في العيش الآمن، إذ لم يصدر -حتى هذه اللحظة- قانون معنيّ بحماية المرأة، رغم وجود مقترح تم تجاهله ودفنه في أدراج مجلس النواب، ربما لأنه لا يعد أولوية كرواتب النواب أنفسهم.
ما يجب أن تقوم به الدولة:
⁃ الإسراع بإقرار قانون حماية المرأة، وإدخاله حيّز التنفيذ، وإعطاء المساحة اللازمة للقضاء كي يمارس مهامه بعيدًا عن القوى الاجتماعية المتمثلة في مشائخ القبائل أو أهل الضحيّة، والتأكيد على ضرورة المحاسبة وفضح الجناة.
⁃ استحداث آليات للإبلاغ والإستجابة، على أن تكون آمنة وسهلة الوصول من قبل الضحايا، كما يجب أن تقوم وزارتا العدل والمرأة بوضع تصور لمراكز الحماية وتقديم الخدمات الصحيّة والنفسية والرعاية الاجتماعية لهن.
⁃ المراقبة والمتابعة والتوعية: يجب أن تطلق المؤسسات المعنية حملات توعية حول العنف الأسري والقتل الموجه ضد النساء، وكذلك مراقبة العنف الإلكتروني الذي طالما أفضى إلى عنف مادي وملموس يؤثر على الضحايا سلبًا.
ختامًا، يقع على عاتق المجتمع المدني مضاعفة عدد المنظمات النسوية والحقوقية العاملة بالرصد والتوثيق، مع مراعاة السلامة والأمن الشخصي للراصدين/ات، والعمل على كشف الحقائق ومواجهة المجتمع بها، بما يموضع واقع الوضع في حجر المجتمع وعلى رأس أولياته! وهو ما قد يساهم في ردع بعض الجناة ويذكرهم أن العرف قد يؤجل الحقيقة، ولكنه لا يقتلها.
وعلى المجتمع الدولي كذلك أن يزيد من اهتمامه ودعمه لقضايا المرأة، حسب الاحتياجات الحقيقية النابعة من قراءة المجتمع المدني للواقع، لا بتقديم الدعم ضمن برامج معدة مسبقًا لا تستهدف المشكلة بقدر ما تدور حولها.