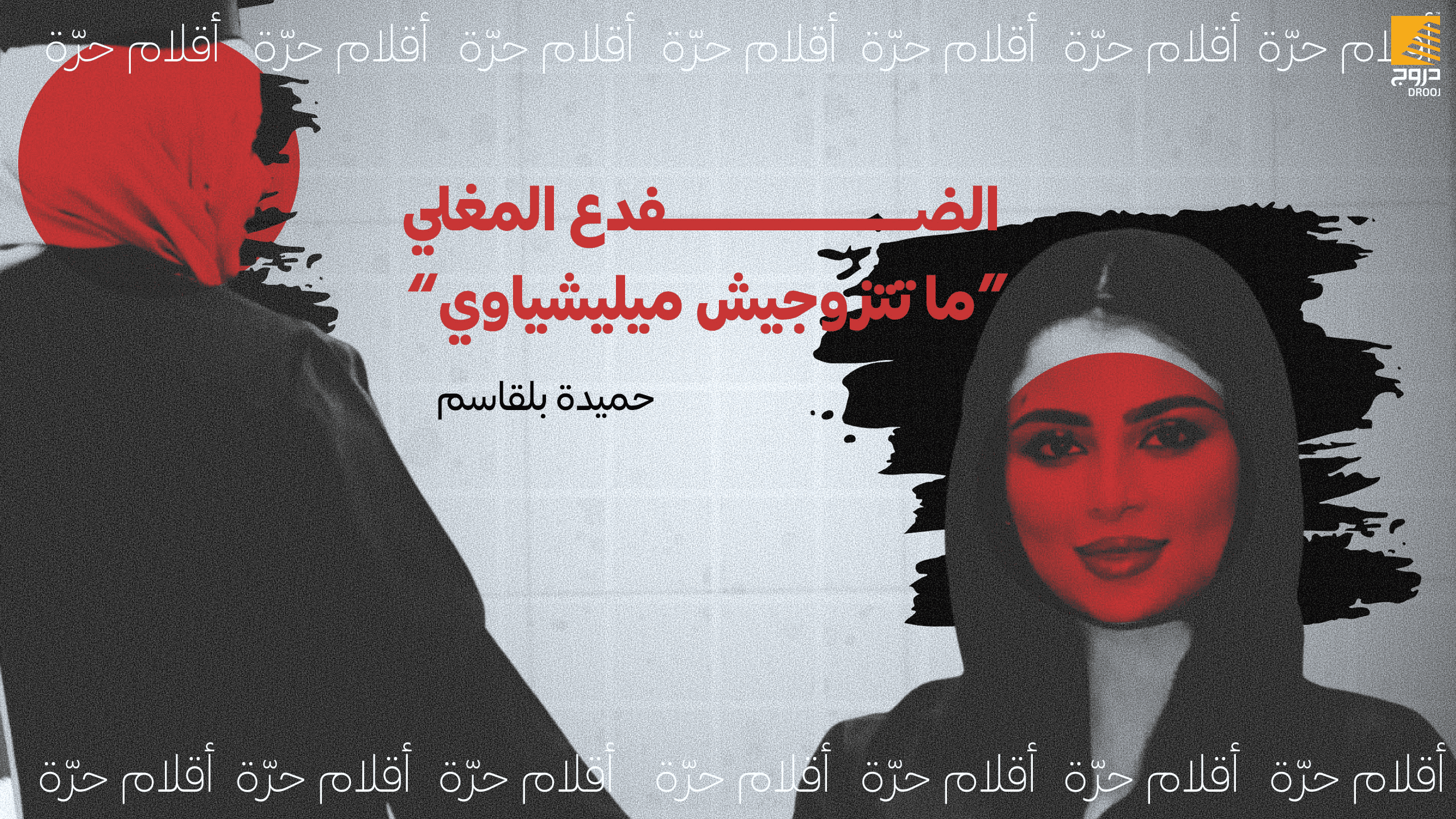منصور عاطي: صرخة أخيرة في وجه المجتمع
في الآونة الأخيرة، تزايدت بشكل ملحوظ قضايا قتل الآباء لأطفالهم، حتى بدا أنه لن يمر يوم تالٍ دون جريمة أخرى، في مختلف مدن البلاد. وعلى سبيل الذكر لا الحصر، ما حدث مع الطفل إسماعيل دنف في مصراتة نتيجة ضرب مبرح من أبيه، ومثله في طبرق الطفلة أسيل العوامي التي تم تعذيبها (خنقا وحرقا) باستخدام أدوات حادة من قبل زوجة أبيها. ولعل أكثر هذه القضايا فجيعة ما حدث في بنغازي لأطفال تم قتلهم من قبل والدهم، الذي قرر أن يقتل نفسه أيضاً، حسب ما تم نشره من استدلالات. انتهاءً بما حدث في مدينة أجدابيا من ضرب أبٍ لابنه البالغ أربع سنوات، ثم فجأة تذكّر أنه يجب أن يقوم بمعالجته. هذه الأبوّة الكاذبة أوقعته في شر أفعاله.
هذه القضايا وأخواتها تُعدّ أمثلة صارخة على الانهيار النفسي والأخلاقي الذي بدأ يطفو على السطح، ويدفع فاتورته الأطفال بمفردهم، بعد كل هذه السنوات المحفوفة بالعنف والتوتر والضغط النفسي، في مقابل حزمة كبيرة من الخرافات والأساطير التي تعمل على تحييد المشكلة عن أصلها وموطن وجعها الحقيقي.
ولكن على ما يبدو أن كل خرافات الأرض غير قادرة على احتواء الظواهر النفسية، وهذا ما يجعلنا نُعيد تفكيك المشكلة والإشارة إلى بعض المغالطات التي أوصلتنا إلى هذا الوضع.
الضرب كإرث تاريخي
ما يحدث هو أمر أطر له الإنسان منذ القدم، أعني هيمنة السلطة (الأبوية)، وأوجدوا الذرائع على طول الخط لضمان هذه السطوة، وتلاعبوا بالألفاظ والمصطلحات، فأصبح الضرب “تأديبًا”، وبهذا يحق للأب “تأديب” أبنائه. وفي هذا يُنسب لأفلاطون وأرسطو أنهما اعتبرا “التأديب الجسدي” ضرورة لتربية ما أسمياه “المواطن الصالح”. ثم جاءوا بمصطلح “الحماية” كتبرير آخر للضرب، وهكذا اتخذ “الضرب” أشكالًا عدة، ومع إجبار الأطفال على العمل، أصبح الأطفال “يُضربون” من أجل الإنتاج.
لهذا، وبشكل أساسي في ليبيا، عشنا هذه الحالات مجتمعة عبر قنوات متتالية: من البيت إلى المدرسة إلى الشارع، وحتى الجنود الذين يعملون على حمايتنا، هم تعلّموا ذلك بالضرب أيضًا.
“كلنا ضربونا هلنا.. وما صارنا شي”!
هذه إحدى المغالطات الحديثة لتبرير استمرار السطوة الأبوية التي لم تكتشف بعد طرقا سلمية للتربية.
يقول أحدهم: “صح هلنا ضربونا، لكن عشان مصلحتنا، ولقينا أرواحنا بعد كبرنا!”. من قال هذه الجملة غالبا لم يجد مصلحته ولا حتى نفسه، هو إنسان تائه قام بالتطبيع من أجل الممارسة. نحن نقول ذلك من أجل أن نُعيد كل ما تم ممارسته علينا، دون وعي أو بوعي نُمرر الإساءة على شكل تربية، نقتص من آبائنا عن طريق أطفالنا.
أتعلمون أين المشكلة؟ أن الضرب أخرج لنا جيلا مهزوما نفسيا، لا يثق في نفسه.
كل من يظن أنه بخير، فلينظر إلى أطفاله. ما يحدث اليوم هو نتيجة حتمية لما حدث بالأمس.
ذات يوم قال الصادق النيهوم: “الطفل مشروع إنسان”، ولو كان حيًّا لشاهد بأم عينه كيف انهار هذا المشروع برمّته، بل كيف يتم قتله يوميا باسم التربية والفضيلة.
“تصير حتى في أوروبا!”
هذه المغالطة تُبيّن مدى التناقض. فأوروبا التي نستشهد بها هي ذاتها التي تأخذ منا أبناءنا إذا ما تعرّضوا لعنف منزلي، ولكننا نأخذ بعض الحديث ونترك البعض. وهي حالة جماعية تساهم في التطبيع والتصالح مع أي كارثة تحدث معنا، ولعلها أشبه بالإيهام الذاتي بشرعية الظلم لأننا نعجز عن تغييره.
قد يسمع الجارُ جاره وهو يضرب ابنه حتى الموت، ولا يتحرك له جفن.
وعندما يطالب أحد ما بضرورة وضع قانون يحمي الأطفال، أو يُلقي باللوم على السلطات، تنهال عليه مئات المسبّات من “مدّعي الفضيلة”، في حالة إنكار جماعية يحاول المجتمع أن ينفي المشكلة، المشكلة التي تقبع في داخل كل أحدٍ فينا، ولا يريد أن يعترف بها.
ولكنها واضحة في تبرير القمع بشكله العام والموجّه ضد الناس من طرف السلطة. نراه في مشاهد إذلال الناس لأنفسهم أمام “الحاكم”، ونسمعه في جملة: “نحن شعب يمشي بالعصا”!
“ما تفرّس نين تهرّس”!
المغالطة الثالثة تكمن في تحوير مقصد هذا المثل الشعبي المقيت، فهي تذكرة مجانية “لتهريس” الأطفال كي يكبروا فرساناً، رغم أنهم لن يكبروا أسوياء. حتى وإن صادف أحدهم الحظ وأصبح فارساً، في الغالب سيكون “فارساً بلا معركة” في أحسن الأحوال. وأكبر دليل ما نراه اليوم من حالة خنوع وهزيمة معنوية وتبرير للظلم، كلها عقد نفسية جلبها الآباء معهم في رحلتهم الطويلة القائمة كلها على “شَشّه كخّة”.
لنتوقف عن الحيل النفسية، ولنَهتم بتربية أبنائنا بالرفق واللين، وليس مهماً أن يكونوا فرسانًا أم لا، فقط ليكونوا أناساً أسوياء أولاً. لنحترمهم بشكل يليق بإنسانيتهم، وليس بطريقة “الراجل ما يبكيش”، لأن البكاء حالة طبيعية تصيب الإنسان، رجلاً كان أو غير ذلك. حتى صغار التماسيح تبكي، ولا أعرف لماذا تم التشكيك ووصم دموع التماسيح أصلًا؟
إعمار الإنسان أولى من البنيان
والآن، وبعد كل هذه الأرواح البريئة التي قُتلت، أما آن الأوان أن تتوجه الجهود نحو مبادرة وطنية تهتم بأمور الناس النفسية؟
يجب منع الضرب في المدارس، وإطلاق برامج للدعم النفسي الأسري.
يجب أن نعلم أن “اللي يمشي لطبيب نفسي مش مكلوب”، وضروري أن نرفع الوصم ونفتح المراكز والعيادات.
يجب أن تستعين وزارة التعليم بأطباء نفسيين ومعالجين لتدريب أعضاء مكاتب الخدمة الاجتماعية والصحية.
يجب أن نترك أطفالنا يتحدثون بدل أن نرهبهم ونجعلهم ضعفاء الشخصية.
يجب أن تتم زيارة السجون والحديث مع الجناة لمعرفة لماذا فعلوا ذلك.
يجب أن تكون هناك خطوط مفتوحة دائماً للإبلاغ وتقديم المشورة والدعم.
يجب أن تكون هناك مراكز للأطفال على غرار مراكز المرأة أو الشباب.
وقبل كل هذا يجب أن نعيد فهم سؤال التنمية، ومعرفة أن التنمية ليست مشاريع بناء وتشييد المباني، بل بناء طفل سليم نفسيًا، ونشيّد جيلاً لا يمارس العنف في المستقبل كحد أدنى.
فأي تنمية لا ترتكز على حقوق الإنسان، هي تنمية خاسرة سلفًا، لأن الرهان الحقيقي على الإنسان لا البنيان.