صفية العايش: “كيف فقدت ليبيا تنوعها البيولوجي؟”
في عام 1972، قتل صياد محلي بسلطنة عُمان (تحديداً بصحراء الربع الخالي) آخر مها عربية تعيش في البرية، ولم تبقَ منها سوى أعداد صغيرة تعيش في الأسر، ومن هذه الأعداد الصغيرة قامت سلطنة عُمان بعد ذلك بعشر سنوات بمحاولة إعادة اكثار المها العربية وحمايتها ومن ثم إعادتها إلى البرية. نجحت التجربة العُمانية وتزايدت أعداد المها العربية لتشمل مناطق أخرى، إلا أن المها ظلت مهددة بالانقراض رغم كل ذلك، فلم تفلح الجهود كثيرا في الإبقاء على هذه الحيوانات بفعل الصيد الجائر.
في نفس الوقت، وبالاتجاه شمالا ناحية القارة الإفريقية، حظِيَت المها الإفريقية “مها أبو حراب” التي كانت تستوطن ليبيا وبلدان الشمال الأفريقي بمحاولات خجولة، من بينها محاولة حديقة الحيوان بطرابلس في التسعينات التي باءت بالفشل بسبب ضعف الإمكانيات والتنسيق مع الجهات الدولية المختصّة، وانقرضت هذه الحيوانات من البرية الليبية نتيجة الصيد الجائر قبل ذلك بسنوات طويلة، وتم اصطياد آخر مها من البرية الليبية حوالي عام 1970، بعد أن اقتصر وجودها النادر على أماكن محدودة جنوب جمهورية تشاد. ويُعتقد أن التغير المناخي كان له أثر محدود على تناقص أعداد المها والحيوانات البرية بمجملها، حيث أن نسبة ارتفاع درجات الحرارة والاحترار العالمي قد زادت من حدة الضغط الإيكولوجي ونقص هطول الأمطار، إلا أن عمليات الصيد الجائر كان لها الأثر الأكبر، فالحيوانات البرية بأنواعها كانت غذاء للسكان وللجنود في الحروب الاستعمارية خلال القرن العشرين، بالإضافة إلى أن الكثير من الجنود إبان الحرب العالمية الثانية كانوا يصطادون الحيوانات البرية في ليبيا لأغراض المتعة، ويأخذون جلود هذه الحيوانات وقرونها كتذكارات قبل أن يعودوا إلى مواطنهم.



الصيد والاقتلاع الجائر
يُعرّف الصيد الجائر بأنه الصيد غير القانوني في مواسم معينة غير مصرح بالصيد خلالها، وباستخدام أسلحة ممنوعة، وبأعداد كبيرة تؤدي إلى تهديد التنوع البيولوجي للمنطقة، حيث يعتبر التنوع البيولوجي جزءًا من الإرث الثقافي للشعوب من جهة، كما يساهم في توازن البيئة وعدم اختلالها من جهة أخرى، إلا أن الصيد الجائر يعتبر حدثا رائجًا يشمل الحيوانات والنباتات على حدٍ سواء؛ فيما يُعرف باسم “الاقتلاع أو الجمع الجائر”. ففي ليبيا، ومنذ ما قبل الميلاد، تذكر الآثار القديمة تعرض نبات السيلفيوم للانقراض قبيل القرن الأول الميلادي بقليل، وهو من النباتات التي كانت تنبت في منطقة الجبل الأخضر، حيث تعرض لمجموعة من العوامل البشرية التي شملت الرعي الجائر الذي أدى إلى تدمير الموائل الطبيعية، والاقتلاع الجائر الذي أدى إلى تناقص أعداده بشكل كبير، فقد كان يُعتقد لوقت طويل أن نبات السيلفيوم يشفي جميع الأمراض وهو ما أدى إلى انقراضه من مناطق تواجده بسبب بيعه على نطاق واسع واستخدامه كعلاج.

في الوقت الحاضر أيضا تمر نباتات أخرى برية في ليبيا بذات المشاكل، مثل أشجار البطوم التي تتعرض للرعي الجائر والمكثف بالجبل الأخضر، بالإضافة إلى نبات البابونج “الفلية” جنوب مدينة مصراتة، والذي يواجه خطر الاضمحلال بسبب الاقتلاع الجائر والزحف العمراني، بالإضافة إلى “عشبة الزريقة” التي أصبح وجودها نادراً ومحصوراً في مناطق معينة بسبب استخدامها الواسع في الطب الشعبي.
كما تذكر مِسِز تولّلي في كتاب “عشرة أعوام في بلاط طرابلس” أن حيوانات النعام كانت تتواجد جنوب مدينة طرابلس قبل أن تنقرض من البيئة الليبية عام 1945، حيث أدى الصيد الجائر وتجارة ريش النعام وتصديره إلى أوروبا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين إلى انقراض النعام من البيئة الليبية، بعد أن تعرض النعام للصيد الجائر لغرض الإستفادة الاقتصادية، ورغم محاولات الدولة إعادة النعام إلى البيئة الليبية عن طريق استحداث المحميات واستجلابه، إلا أن الأمور لم تسر كما خطط لها بسبب انعدام الكفاءة الوظيفية للقائمين على المشروعات، وعدم جدية الخطط وكفايتها.
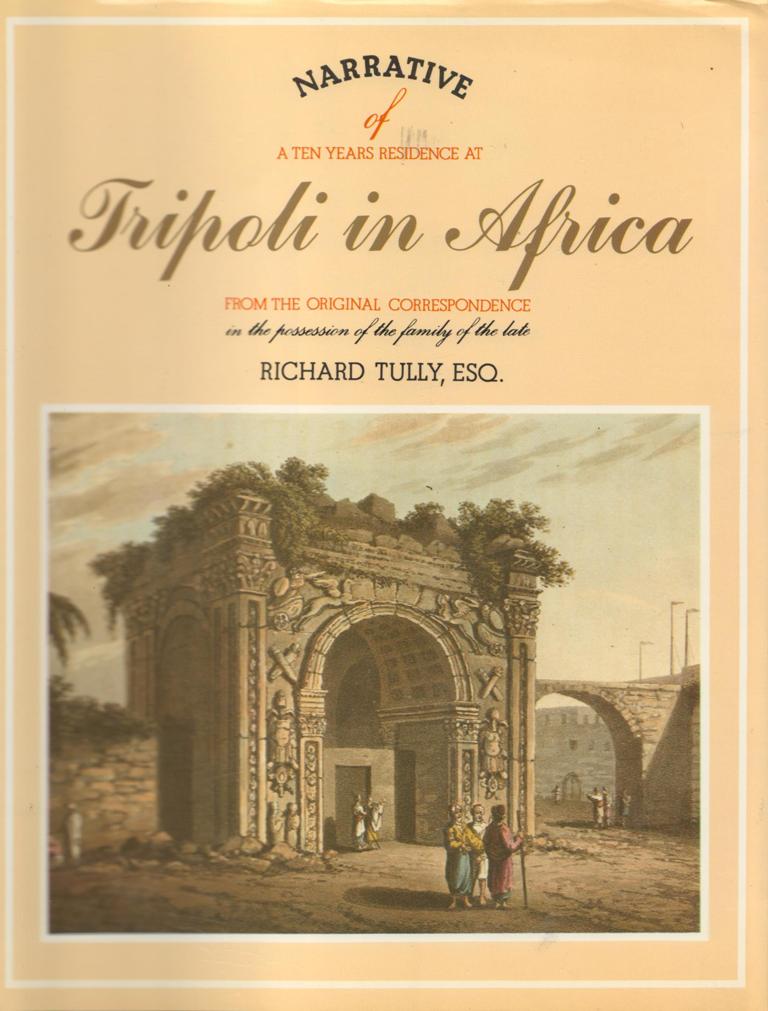


الزحف العمراني
يتحول النمو غير المتناسق وغير المخطط للمباني إلى مشكلة تهدد التنوع البيولوجي، حيث يسبب الزحف العمراني الخرساني في تدمير المناطق البرية والموائل الطبيعية التي تعتمد عليها الأنواع لبقائها في البيئة، وبالتالي تؤدي هذه الممارسة غير الممنهجة إلى الانقراض المحتمل لكثير من الأنواع الحيوانية والنباتية، وكذلك إلى تقليل حجم الغابات والمناطق الخضراء مما ينتج مشكلات مناخية وانخفاضا في مستوى الأمطار، وهو ما يؤثر سلباً على الحيوانات والنباتات ويؤدي إلى اضمحلال التنوع الحيوي في الأماكن المحيطة به، حيث أن الحيوانات البرية تقوم بتوزيع نفسها طبيعيا اعتمادا على خواص الأرض والظروف البيئية والمناخية المناسبة من حيث التوزيع النباتي والغذائي، مما يعني أن الزحف العمراني -في المقابل- يعمل على الضغط على الحيوانات كي تهجر مواطنها الطبيعية إلى مناطق وعرة حتى تندثر في النهاية، فالغزلان (غزال دوركاس وغزال آدم)، التي كانت تستوطن المناطق شبه الصحراوية جنوب الجبل الأخضر قد نزحت إلى الصحراء بعد أن تناقصت أعدادها بفعل ملاحقة الصيادين وزحف العمران البشري، الذي أدى إلى تبدل نوعية الغطاء النباتي وانحساره، وهو ذات المصير الذي يواجهه حيوان “الودّان” الذي أصبح وجوده نادرا في الصحاري، وتحولت ندرة هذه الحيوانات إلى تحدٍّ للصيادين الذين يجدون متعتهم الحقيقية في اصطياد الحيوانات النادرة.
ويذكر الروائي “ابراهيم الكوني” هذه الجدلية من خلال روايته “نزيف الحجر” التي قام بنشرها عام 1990، وناقش من خلالها القضايا البيئية وعلاقة الإنسان بالحيوانات البرية (تحديدا الغزلان وحيوان الودّان) من وجهة نظر مدمني الصيد الذين يقومون بانتهاك النظام البيئي، إلى أن تؤدي ممارساتهم في النهاية إلى انقراض الأنواع واندثارها، حيث صوّر من خلال شخصيات روايته توغّل الإنسان وانتهاكه للنظم البيئية بفعل أدوات الحداثة مثل البناء العشوائي، بالإضافة إلى الأسلحة وسيارات الدفع الرباعي التي استخدمت لملاحقة الحيوانات على نطاق واسع.


تغيرات المناخ و التصحّر
في يونيو عام 2002، قررت دول إفريقية عدة من بينها ليبيا إنشاء حواجز طبيعية في وجه ظاهرة التصحر وزحف الصحراء، وتمثلت هذه الحواجز في ما أطلق عليه مشروع “الحزام الأخضر الإفريقي” الذي وضع خطة معينة لزراعة عدد ضخم من “أشجار الأكاسيا”، حيث كان هدف هذا المشروع هو وقف زحف الصحراء ومحاولة إعادة الغابات إلى مستواها الطبيعي. وقد اعتبر هذا المشروع آنذاك نواة لتوحيد الجهود الإقليمية في مجال مكافحة التغير المناخي، إلا أن هذا المشروع قد تعثر بسبب انعدام الاستقرار السياسي الذي يجتاح القارة الإفريقية، ورغم كل الوعود التي صاحبت إطلاقه من حيث النتائج الكبيرة والمرضية واعتباره عاملا مساعدا في تقليل كوارث الجوع والفقر وكوارث اجتماعية واقتصادية أخرى، وعاملا مساعدا أيضا في المحافظة على التنوع الحيوي وتعزيزه، إلا أن نتائج هذا المشروع جاءت مخيبة للآمال وأصبح مع مرور الزمن مجرد حلم لم يتحقق بسبب انعدام الاستمرارية، وبسبب سياسات الدول التي كانت متقلبة بالإضافة إلى عوامل مثل غياب الوعي المحلي في هذه البلدان، فمفهوم التصحر يرتبط في الغالب بظاهرة قطع الأشجار لاستعمالها كوقود (الفحّامات)، وهي العادة التي دمرت الكثير من الغابات والمناطق الخضراء في ليبيا وأدّت إلى ندرة أشجار الطلح “الأكاسيا” في مناطق الجنوب الغربي، حيث تم ابادة هذه الأشجار في فترات زمنية مختلفة، خصوصا في ظل فقر السكّان وغياب سلطة القانون عام 2011، مما أدى إلى اعتبار هذه الأشجار مهدّدة بالانقراض داخل البيئة الليبية.

وكتب الإيطالي أوجستو توسكي عام 1969 كتاب “الطيور الليبية”، والتي حصرها فيما يقارب ثلاثمائة طائر موزعة بين طيور مقيمة ومهاجرة، وقد أدى القطع الممنهج للأشجار إلى تدمير الموائل الطبيعية لهذه الطيور، بالإضافة إلى أن عوامل مختلفة مثل التغيرات المناخية وظاهرة التصحر يجعل أعدادها في تناقص مستمر (كطيور الحجل والزرزور المهاجر). كما تتعرض سنويا لموجات كبيرة من الاعتداءات من قبل الصيادين، فطيور الحبارى أصبحت مهددة بالانقراض بسبب تدمير أعشاشها، بينما أصبح صيد الصقور والمتاجرة بها بسبب ارتفاع أسعارها يهدّد هذه الحيوانات التي أصبحت أنواع كثيرة منها ضمن القائمة الحمراء للأنواع المهددة.
قوانين غائبة وسياسات بديلة
تنص المادة (56) لقانون رقم (15)، للعام 2003، المختص بالبيئة على أنه “يجب المحافظة على الحيوانات والطيور البرية وحمايتها من الانقراض (وعلى الأخص الحيوانات النافعة). وفى سبيل ذلك يجب تخصيص وتحديد مناطق محمية يمكن من خلالها المحافظة على هذه الحيوانات والطيور البرية ويمنع الصيد فيها بتاتا ضماناً لتكاثرها”.
وقد أضيف لهذا القانون العديد من المواد؛ من بينها تلك المواد التي تحظر الصيد البحري باستخدام المتفجرات (الديناميت)، والذي ما يزال يستخدم من قبل الصيادين على نطاق واسع ويؤدي إلى تدمير الموائل البحرية، إلا أن هذه القوانين لم تُطبّق على نطاق واسع لأسباب متنوعة، ولتشظي الدولة الليبية ما بعد الربيع العربي بفعل الانقسام السياسي وانتشار السلاح، الذي أثّر سلباً على البيئة والتنوع الحيوي وأدى إلى انتشار ظاهرة الصيد الجائر.
وفي ظل غياب سيادة القانون تقدّم الحكومة وعودها للخارج من خلال تواجدها الصوري في مؤتمرات البيئة والمناخ دون وجود نتائج ملموسة داخليًا، وهو ما يجبر النشطاء المستقلين و بعض المنظمات البيئية القليلة لقيادة حملات توعوية بمجهودات فردية يغيب عنها الدعم الحكومي، قائمة بشكل أساسي على الحد من مخاطر إزالة الغابات وتعزيز ثقافة التشجير وإن بشكلٍ محدود، خصوصاً مع عزوف الدولة (من خلال سلطتها التشريعية) عن تطبيق تعديلات قوانين الصيد الجائر وحماية المحميات الطبيعية التي تم تقديمها كمقترحات للبرلمان، والتي حرصت على تضمين مشاكل أخرى مثل حظر استخدام الأراضي الزراعية كمشروعات سكنية وحماية الغابات.

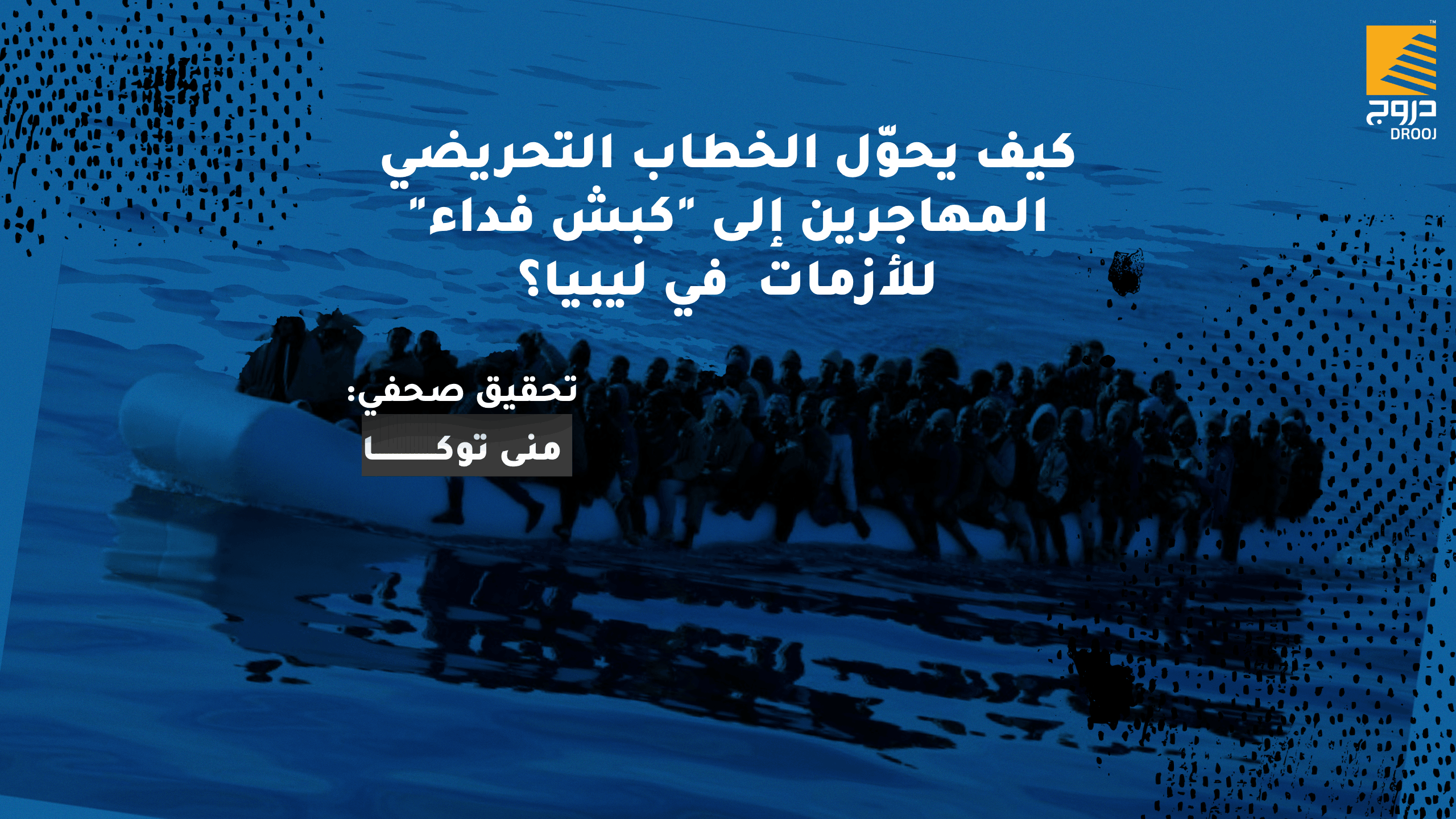
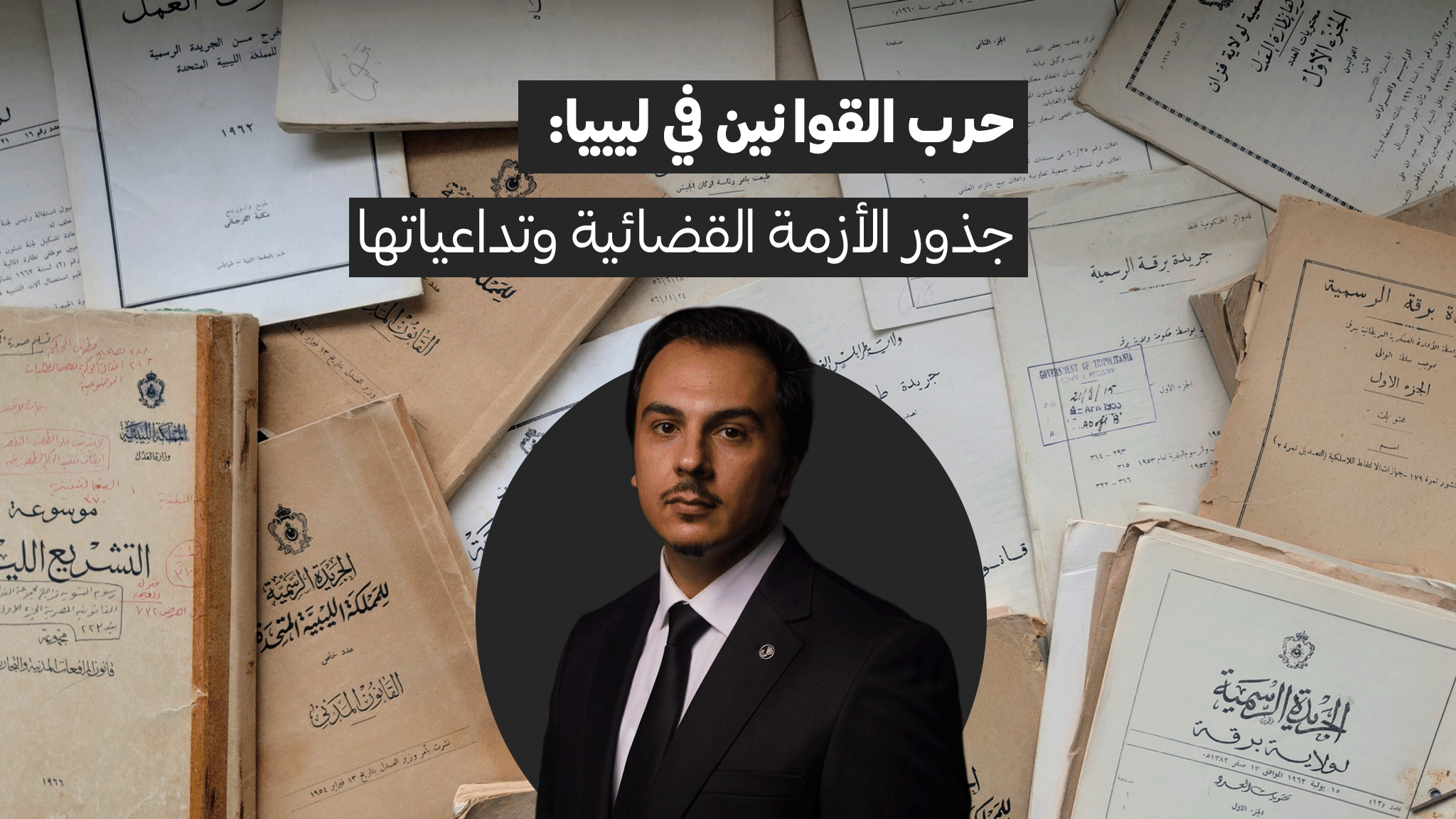









إرسال التعليق