خدمات ثقافية متواضعة، ليست للجميع – الجزء الثاني
بقلم / حسام الثني – خاص.
الجزء الثاني: عوائق الوصول
هل المرافق الثقافية في ليبيا مصممة للجميع؟ تحدثنا في الجزء الأول من هذا المقال عن الخدمات الثقافية، والحقوق الثقافية، وقادنا ذِكرُ حق الوصول الثقافي، إلى ضرورة الحديث عن أبرز العوائق التي تحول دون وصول فئات المجتمع إلى الفضاء الثقافي العام. عوائق الوصول، إذن، هي موضوع الجزء الثاني من مقالنا عن الخدمات الثقافية:

عوائق جسدية:
“ربيعة عمر خليفة“، وهي مهندسة في وضعية إعاقة، نشطة في مجال التصميم الشامل، تخبرنا أن العائق الأول لوصول الأشخاص في وضعية الإعاقة، هو غياب مبدأ (التصميم الشامل). فما التصميم الشامل؟
يمكن النظر إلى التصميم الشامل على أنه مقارَبة جديدة للنظر إلى معايير جودة التصميم (العمراني على وجه الخصوص)، وهي نظرة تراعي الاحتياجات المتنوعة لمختلف فئات المجتمع، وناقدة للأنماط السائدة في التصميم التي لطالما صممت الفضاء العام والرقمي لفائدة نموذج بشري محدد (إنسان قياسي)، دون النظر إلى حاجات قصار القامة، مثلا، وطوال القامة، ومستعملي العصا البيضاء، والكرسي الرمادي، وضعيفي السمع والبصر، ومن يتّسمون بعمى الألوان، ومستعملي اليد اليسرى، وضخام الحجم، وكبار السن، والأطفال، ومبتوري الأطراف، وذوي الجهد العضلي المحدود، ومن هم في وضع إعاقة خفيّة.

تخبرنا ربيعة أن (عوائق الوصول) لا تقتصر على الفضاءات الثقافية فحسب، بل تعد مشكلة عامة تطال عموم الفضاء العام في ليبيا، وما جاورها. وأن أغلب المرافق العامة تفتقر إلى أبسط معايير التصميم الشامل من: مرونة الاستخدام، وتحقيق المساواة في الاستخدام، وتوفر الفضاءات المدروسة.
تسرد لنا مثالا تجسّد في صعوبات واجهتها أثناء ولوجها إلى المسرح الشعبي في بنغازي: “تعثّر دخولي من الباب الرئيسي، الأمر الذي يبين تعارض التصميم مع “مبدأ مساواة الاستخدام”، واضطررت إلى الدخول من باب جانبي تصعب المناورة فيه بالكرسي المتحرك، واضطر بعض الرفاق إلى حملي لأتجاوز الدرج، ولأجد نفسي في النهاية في مكان معزول في الصف الأول، دون أن تكون لي حرية اختيار موقع آخر للمشاهدة، أو حرية الجلوس بالقرب من الرفاق”.

عوائق جغرافية:
يقودنا الحديث عن العوائق الجغرافية، إلى ضرورة الإشارة إلى مفهوم آخر، هو (دَمَقْرَطة الثقافة).
يمكن تعريف (الدَّمَقْرَطَة) على أنها عملية الانتقال السلس من نظام سياسي إداري مركزي إلى نظام أكثر إشراكا لأفراد المجتمع، ووفق هذا المبدأ فَصُنَّاع السياسات الثقافية ملزمون بتوسيع دائرة الإشراك في صوغ الخطة الوطنية للثقافة، وتنفيذها، لتشمل إسهام فاعلات وفاعلين ثقافيين من مختلف فئات المجتمع، بما يضمن إشراك الفئات الأكثر عزلة جغرافية واجتماعية وثقافية ولغوية وجندرية وجسدية، وملزمون أيضا بتنمية معارف هذه الفئات ومهاراتها وأدواتها، بما يضمن تمكينها من إدارة خدماتها الثقافية بنفسها، وتطويرها وفق حاجاتها.
بل يتجاوز الأمر إلى ضرورة إشراك هذه الفئات في صوغ السياسات الثقافية للدولة، بما تشتمل من إسهام في صوغ (التعريف الوطني للثقافة)، و(التعريف الوطني للفنّان)، وقول رأيها في تحديد (ما هو فَنّي، وما ليس فَنّيا)، ولا بدّ لكل ما سبق أن يقود بالتبعية إلى ازدهار الفضاءات الثقافية والممارسات الثقافية في المناطق المعزولة جغرافيا.
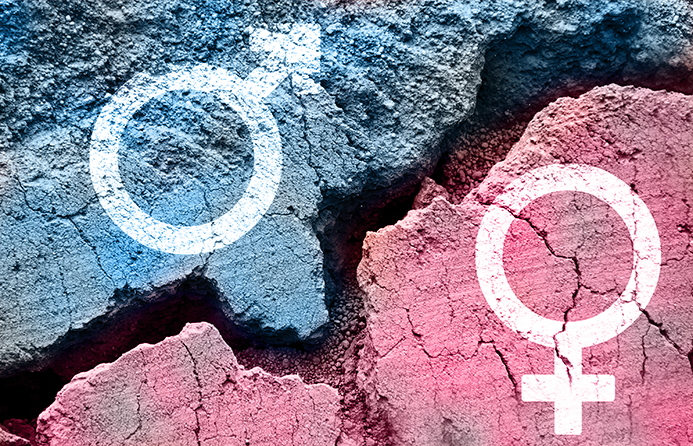
يخبرنا “حسن بوكتو“، من القطرون، أنه لم يدخل في حياته إلى أي مسرح، أو قاعة سينما، أو متحف، ولم يحضر حفلا موسيقيا واحدا، باستثناء الحفلات التي تقام في الأفراح، وأنه لم يزر أية مكتبة عمومية، أو معرض فنون تشكيلية، ولم يحضر مباراة في أي ستاد رياضي. وعلى رغم أنه يكتب بعض الخواطر الأدبية، ويعمل على تطوير مهاراته في الرسم بالأصباغ والألوان الزيتية متى توفرت له؛ فهو لم ينخرط في أي نشاط فني جماعي، ولم ينضم إلى أي نادٍ أدبي أو فني.
وعلى رغم أن سكان المدن الليبية الكبرى بدورهم، كثيرا ما يعيشون الوضع ذاته، في ظل قلة المرافق الثقافية، وتواضع خدماتها، وضعف سياسات الدولة في التعريف بها والترويج لها؛ إلا أن الفارق بين توفر المرافق الثقافية في مدن الشمال الليبي مُقابلةً بجنوبها؛ يبدو شاسعا، بقدر غير عادل، لمصلحة مدن الشمال.
مَرْكَزَة المرافق الثقافية في الحواضر الكبرى على حساب التمدد الأفقي الطبيعي لها؛ أمر تكرر في تجارب دول مجاورة، منها التجربة التونسية في إنشاء “مدينة الثقافة”، التي بدت ظاهريا صرحا ثقافيا هاما، والواقع أنها – لدى بعض الفاعلين الثقافيين – محل شَكّ في مدى نجاعة إسهامها في تنمية قطاع الثقافة التونسي؛ إذ عوضا عن دعم مساعي دَمَقْرَطة الثقافة؛ عملت مدينة الثقافة على تكريس مَرْكَزَة الثقافة، وجاء نجاحُها على حساب (الصناعات الثقافية) التي كانت مزدهرة نوعا ما في المسارح والمراكز الثقافية غير الحكومية الكائنة في الأزقة المتاخمة لمقر مدينة الثقافة، التي لم تجد المقدرة على الاستدامة والتنافس مع العملاق الخدمي الحكومي.

عوائق ثقافية اجتماعية:
تخبرنا “ريحانة العمامي“، وهي مرشدة نفسية، أنها هي الأخرى لم تحضر يوما مباراة كرة قدم أو كرة يد أو كرة طائرة في ملعب مخصص لهذه الأغراض، على رغم توفر المرافق الرياضية في مدينتها. تخبرنا أيضا أنها لم تحضر عرضا مسرحيا واحدا في بنغازي ولا طرابلس، ولم تزر متحفا إلا خارج ليبيا. وتعزي الأمر إلى سببين:
الأول عائق ثقافي اجتماعي متمثل في نظرة المجتمع تجاه المرأة، التي تبعدها عن الفضاء العام؛ فالملاعب الرياضية مثلا محتكرة من قبل الذكور، وحتى في الحالات النادرة التي يمكن للمرأة أن تتواجد فيها، فإنها في الغالب لا تحس بالأمان الكافي الذي يسمح لها بقضاء وقت ماتع بأريحيّة.
أما العائق الثاني، والمرتبط أكثر بالمرافق الثقافية، فهو أن هذه المرافق ليست جاذبة للمتلقي، لفرط إهمال القائمين عليها، وعلى الترويج لها، وكثيرا ما يعيش الأفراد حياتهم في ليبيا ويموتون دون أن يسمعوا بأنْ ثمة مسارح ومتاحف في مدينتهم. بالإضافة إلى رداءة الخدمات المكمّلة للسياحة الثقافية، من شبكة مواصلات عامة، وخدمات فندقية، ومقاهي ومطاعم ودورات مياه عامّة، وغياب عنصر الأمن، وهو ما يمكن الوقوف عليه في زيارة لمدينة “قورينا” الأثرية مثلا، أو “لبدة الكبرى”، أو “صبراته”، وكذلك منتزه بنغازي “البوسكو”، أو “بودزيرة”، أو “شلال دَرْنَة” واستحالة وصولك إلى “كهف مرقس”، وموقع “أكاكوس”.

خاتمة:
لا يبدو أن المرافق الثقافية في ليبيا قد أُنشئت لتقدم خدمات ثقافية لكافة أفراد المجتمع؛ فهي مركّزة في مدن محددة، وصعبة الوصول لدى شريحة واسعة من المجتمع. ونكاد لا نعرف على وجه الضبط لماذا أُنشِئت؟
المتاحف على سبيل المثال: لا تبدو أنها أُنشِئت لأغراض تعليمية؛ فهي غير مبرمجة في الأنشطة المدرسية، وليست ذات جدوى واسعة للباحثين، ولا يبدو أيضا أنها مُنشأة لأغراض اقتصادية، فهي غير جاذبة للسياح المحليين والأجانب، ولا تحقق أرباحا ضمن مداخيل الاقتصاد الإبداعي للدولة والمجتمع، ولا يبدو أنها أُنشِئت لأغراض بناء التلاحم الاجتماعي عبر بلورة سردية الهوية الليبية الوطنية، وحفظ التاريخ المشترك؛ فهي مهملة بقدر لا يجعلها ملحوظة بالقدر الكافي لإنجاز هذه المهمة، فلماذا أُنشِئت إذن؟
هل أُنشِئت دون مغزى؟ هل أُنشِئت تقليدا لدول الجوار، وتماشيا مع التقليعات السائدة؟ وهل ما تزال هذه المرافق تؤدي الأغراض ذاتها التي أُنشِئت من أجلها – أيًّا كانت؟ وكيف يمكن إعادة تحسينها، وتحقيق الاستفادة القصوى منها؟
أسئلة لا بد لصاغة السياسات الثقافية في ليبيا، وأصحاب صنع القرار، أن يطرحوها على أنفسهم.


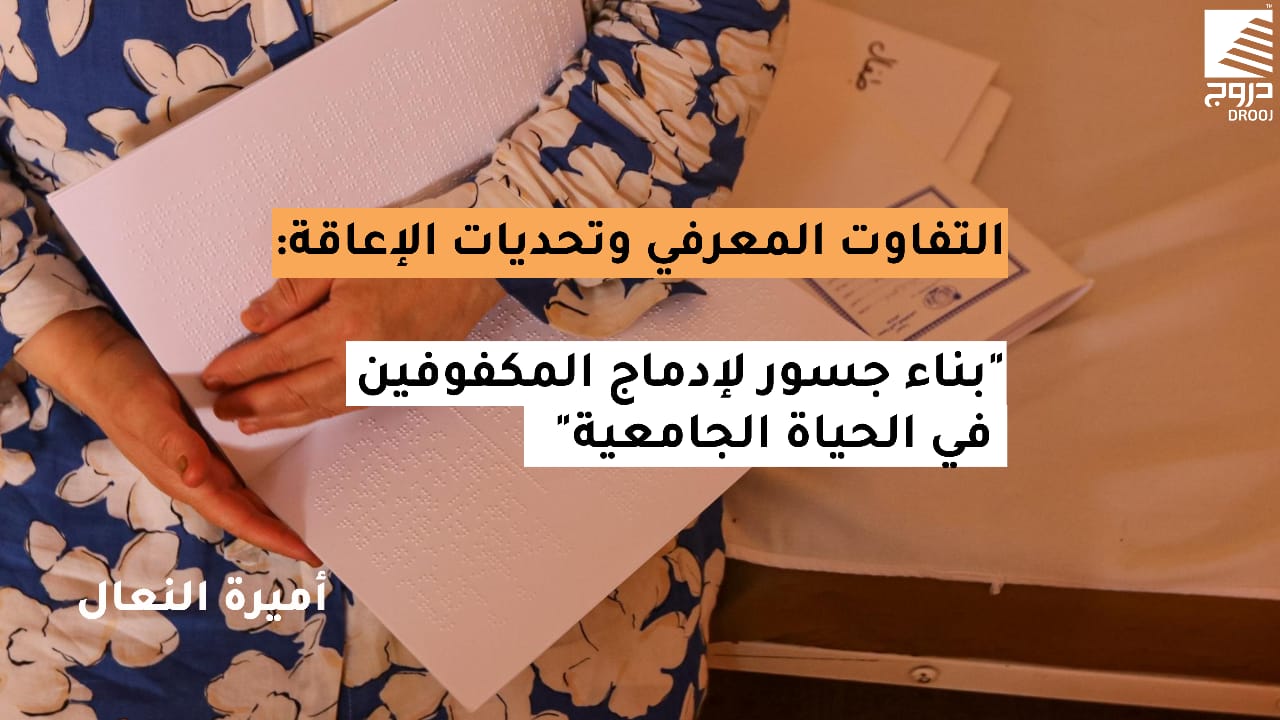









تعليق واحد